د. كريم نفادي يكتب لـ «30 يوم» : الوسطية والاعتدال في السنة النبوية الشريفة

لقد امتاز الإسلام بخصيصة فريدة جعلته صالحًا لكل زمان ومكان، وهي الوسطية والاعتدال، وتُعد السنة النبوية والسيرة العطرة للنبي محمد ﷺ النموذج الأوضح والأكمل في تجسيد هذا المنهج المعتدل، حيث كان ﷺ يجمع بين الصرامة في الحق، والرحمة بالخلق، والتوازن في الحياة، فبعث الله به أمة “وسطًا” لتكون شاهدة على الناس.
ومن أبرز الخصائص التي امتاز بها الإسلام عن غيره من الشرائع والأديان، خاصية الاعتدال، وهذه الخاصية ليست مجرد شعارات نظرية بل هي حقيقة عملية متجذرة في كل تعاليمه وتشريعاته، وتظهر جلية في كل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة النبي محمد ﷺ، سلوكًا وتوجيهًا، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة؛ وذلك لأن الإسلام جاء ليكون الدين الخاتم، ولابد أن يتصف دين الله الخاتم بما يجعله صالحًا لكل زمان ومكان، وكان الاعتدال واليسر من أهم مقومات صلاحيته وخلوده.
وفي هذا المقال نسلط الضوء على مظاهر الاعتدال والوسطية في السنة والسيرة النبوية، من خلال المواقف النبوية العملية، والتوجيهات الحديثية، لنرى كيف جسّد النبي ﷺ وسطية الإسلام في العبادات، والمعاملات، والأخلاق، والدعوة، والقضاء، والتربية.
أولًا: مفهوم الوسطية في الإسلام:
الوسطية تعني في اللغة: التوسط بين الإفراط والتفريط، وهي أقرب إلى معنى العدل والخيرية. قال ابن فارس في “مقاييس اللغة”: “الواو والسين والطاء أصلٌ يدل على العدل والنَّصَف”.
أما في الاصطلاح، فتعني: الاعتدال في جميع شؤون الدين والدنيا دون غلوٍّ أو تقصير، ودون تشددٍ أو تساهل.
وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بالوسطية في قوله: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]
قال الطبري: “وسطًا أي عدلًا خيارًا”.
ثانيًا: مظاهر الوسطية في العقيدة
الإسلام وسط بين الغلو والإلحاد، وبين التثليث والتعطيل، فهو يؤمن بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، دون تشبيه أو تعطيل.
بين اليهود الذين شبَّهوا الله بخلقه والمسيحيين الذين ألهوا الخلق وجعلوا لله ولدًا، جاء الإسلام بعقيدة نقية صافية.
في الإيمان بالأنبياء: الإسلام وسط بين من كفر بهم (كاليهود في حق عيسى) ومن غالى فيهم (كالمسيحيين في عيسى)، فجعلهم بشرًا مصطفَين مكرّمين.
قال النبي ﷺ: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله»،
(رواه البخاري)
ثالثًا: مظاهر الوسطية في الشريعة
1. العبادات:
جاءت العبادات في الإسلام على نحو معتدل لا يشق على النفس السوية، مراعية لطاقات البشر، ودون تحميل فوق الوسع:
قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]
وقد جاء التيسير في السنّة أيضًا، كما في حديث النبي ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا…»، (رواه البخاري).
أمثلة تطبيقية:
رُخَص السفر: كقصر الصلاة، والفطر في رمضان.
الوضوء والتيمم: في حال فقد الماء أو المرض.
قيام الليل: مندوب لا واجب.
تخفيف الصلاة في حال المشقة: كما قال ﷺ: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» (رواه البخاري ومسلم).
2. المعاملات
الإسلام أباح البيع وحرّم الربا، أباح الكسب الحلال وحرّم الغش والاحتكار، ونظّم العلاقات على أساس العدل والرحمة.
قال النبي ﷺ: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» (رواه البخاري).
كما أمر بالتيسير على المعسرين: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]
رابعًا: الوسطية في السنة النبوية: توجيهات نبوية جامعة
1. النهي عن الغلو والتشدد:
الغلو سبب الانحراف، وقد حذر منه النبي ﷺ مرارًا، وفي موقف شهير، جاء ثلاثة من الصحابة يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبِروا بها كأنهم رأوها قليلة، فقال أحدهم: أني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء.
فقال ﷺ لهم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري ومسلم).
وهذا الحديث يبين أن الغلو في العبادة ليس من منهج الإسلام، بل يخالف السنّة، وأن العبادة لا تكون نافعة إلا إذا كانت معتدلة ومستديمة.
2. الاعتدال في العبادة
وكان النبي ﷺ إذا خيّر بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (رواه البخاري)، وفي صلاة الجماعة قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة».
وكان يرخص بالصلاة قاعدًا لمن عجز، وبالقصر في السفر، والفطر في رمضان للمريض والمسافر، وفي هذا دلالة على أن العبادة لا تعني المشقة، بل تقترن بالتيسير والاعتدال.
3. رفع الحرج عن الأمة
قال النبي ﷺ: «بعثت بالحنيفية السمحة» (رواه أحمد).
وفي حديث آخر: «إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين». (رواه البخاري).
خامسًا: نماذج من السيرة النبوية في تطبيق التيسير
1. في الصلاة
عندما مرض النبي ﷺ وخشي أن يشق على الأمة، قال: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» (رواه البخاري).
وفي مرضه كان يصلي جالسًا مراعاة لحاله.
2. في الدعوة
عندما بعث النبي ﷺ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، قال لهما: «يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا، وتطاوعا ولا تختلفا». (رواه البخاري ومسلم).
سادسًا: الوسطية في التعامل والقضاء
1. التسوية بين الخصوم
كان ﷺ يتحرى العدل المطلق عند الحكم بين الناس، ويحرص على الحياد الكامل.
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (رواه البخاري ومسلم).
فحتى وهو القاضي والحاكم، كان ﷺ يُذكّر الناس بمقام العدالة، ويخشى ظلم من لا يحسن الكلام، وهذا غاية في الإنصاف والاعتدال.
2. الرحمة في تطبيق الحدود
عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يُكلم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: أسامة بن زيد، فكلّمه، فقال ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله؟… وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (رواه البخاري ومسلم).
وهذا ليس تشددًا، بل عدالة مطلقة لا تعرف محاباة، وهي قمة الاعتدال القضائي الذي يُزيل الفساد ويحفظ الحقوق.
وجاءه رجل يشتكي جاره، فقال ﷺ: «اصبر»، ثم كررها ثلاثًا، فلما كثر شكواه قال: «اطرح متاعك في الطريق»… فشكا الجار، وتاب. (رواه أبو داود).
سابعًا: الاعتدال في معاملة الأعداء
النبي ﷺ قاتل من قاتله، وعفا عمّن تاب ورجع. لم يكن يحب القتال، وإنما كان وسيلة اضطرارية للردع والدفاع.
في فتح مكة، لما ظن الناس أنه سينتقم، قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (رواه البيهقي، وصححه الألباني).
ولما قُتل رأس النفاق عبد الله بن أُبيّ، ترك النبي ﷺ الصلاة عليه بعدما نُهِي عنها، ولم يُمثل به ولا حرّض على أبنائه، مع أنه آذاه طويلًا.
هذا هو الاعتدال في معاملة الخصوم: عدل بلا ظلم، وعفو بلا ضعف.
ثامنًا: الاعتدال في الدعوة والتعليم:
1. التيسير في الدعوة
حين بعث النبي ﷺ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: «يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا»
(رواه البخاري ومسلم).
وهذه القاعدة الذهبية في الدعوة تمثل جوهر الاعتدال النبوي، وهي دليل على أن التيسير والرفق أقرب للقلوب من الشدة.
2. الرفق بالجاهلين:
جاء أعرابي فبال في المسجد، فقام الصحابة ليزجروه، فقال ﷺ: «دعوه، وأريقوا على بوله ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين» (رواه البخاري).
النبي ﷺ لم يُعامل الأعرابي بجفاء، بل اعتبر جهلَه سببًا للعذر، وربّاه برفق، فحُفِظ المسجد، ورُبِّي الأعرابي، ووقع الموقف في قلوب الناس وقعًا حسنًا.
كما دخل أعرابي المسجد وبال فيه، فثار عليه الصحابة، فقال ﷺ:«دعوه، وأريقوا على بوله ذنوبًا من ماء… إنما بعثتم ميسرين»(رواه البخاري)
تاسعا: الوسطية في الأخلاق والسلوك:
1. ضبط الغضب والتوازن النفسي:
قال النبي ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (رواه البخاري ومسلم).
فالإسلام لا يمنع الغضب تمامًا – فهو انفعال بشري – ولكنه يدعو لضبطه والاعتدال فيه.
عاشرا: التوازن في الإنفاق والطعام والشراب
قال ﷺ لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بكل ماله: «الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (رواه البخاري ومسلم).
فأرشد النبي ﷺ إلى الاعتدال بين البذل والإمساك.
في الطعام والشراب:
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31]
وأخير، فإن من مظاهر الوسطية في سيرته الشخصية:
أنه كان ﷺ يضحك ويمازح أهله وأصحابه، ولا يكون عبوسًا دائمًا.
وكان يأكل ويصوم، ويعمل ويعبُد، ويجتهد ويرتاح.
وقال ﷺ: «إن لربك عليك حقًا، وإن لأهلك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه»
(رواه البخاري).
وهذا الحديث يوجز فلسفة الاعتدال النبوي: لا تهمل حق الله، ولا تنسَ حق النفس، ولا تُفرّط في حق الناس.
أثر الوسطية في صلاح المجتمعات:
وسطية الإسلام ليست ترفًا فكريًا، بل لها آثار عملية عظيمة:
1. الاستقرار الاجتماعي: فالتوازن يمنع التطرف ويعزز السلم.
2. الرحمة في التعامل: فدين ينهى عن التعسير لا يمكن أن يكون دين قسوة.
3. التوازن النفسي: لأن المكلف يعرف أن الله لا يكلّفه إلا وسعه، فيعيش مطمئنًا.
4. القبول العالمي للإسلام: فاليسر والتوازن جعلا من الإسلام دينًا مقبولًا في بيئات وثقافات متعددة.
منهج النبي في مواجهة التطرف
التطرف والغلو صفتان دخيلتان على المنهج النبوي.
النبي ﷺ حذّر الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (رواه البخاري).
دعا إلى الحكمة والرفق:
«ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نُزع من شيء إلا شانه» (رواه مسلم).
الخاتمة
لقد مثّلت السنة النبوية والسيرة المحمدية التطبيق العملي لأعلى صور الوسطية والاعتدال؛ فكان النبي ﷺ إمامًا في التوازن بين الجسد والروح، بين العمل والعبادة، بين الحزم والرحمة، بين العدل والعفو. وقد ربّى أصحابه على ذلك حتى صاروا أمة شاهدة، تحقق الخير وتنأى عن التطرف والانغلاق.
وسطية الإسلام لا تعني التفريط ولا التمييع، بل تعني الاعتدال الواعي والميزان الراشد، وهو ما جسده النبي ﷺ بكل تفاصيل حياته، وسار عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وفي زمننا المعاصر، لا سبيل للخروج من أزمات الغلو والإفراط والتكفير والانحراف، إلا بالعودة إلى السنة النبوية، حيث نور الهداية، ومنهج الاعتدال، وسيرة الرحمة.
كما أن وسطية الإسلام ليست شعارًا إعلاميًا، بل حقيقة قرآنية وسنة نبوية مطبقة، وهي من أكبر الأدلة على أن هذا الدين هو دين الرحمة والعدل واليسر، وأنه صالح لكل الناس في كل زمان ومكان، وقد جسّد النبي ﷺ هذه الوسطية في حياته وسيرته وتعليمه لأصحابه، حتى صار ميزان الدين قائمًا على الاعتدال والتوازن في كل شيء. وما أحوج الأمة اليوم إلى العودة إلى هذه الوسطية النبوية، بعيدًا عن الغلو والتساهل، وعن الانغلاق والتسيب، لتعيش نور الهداية كما أرادها الله: أمة وسطًا.





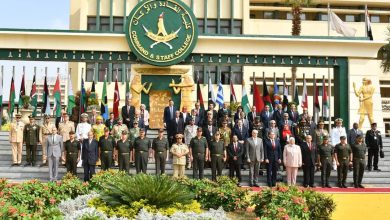
لماذا حظرت بعض الاشخاص من صفحتك على الفيس بوك وألغيت صداقتهم. لماذا لا تعمل بهذا
2. في الدعوة
عندما بعث النبي ﷺ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، قال لهما: «يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا، وتطاوعا ولا تختلفا». (رواه البخاري ومسلم).
سادسًا: الوسطية في التعامل والقضاء
1. التسوية بين الخصوم
كان ﷺ يتحرى العدل المطلق عند الحكم بين الناس، ويحرص على الحياد الكامل.
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (رواه البخاري ومسلم).
فحتى وهو القاضي والحاكم، كان ﷺ يُذكّر الناس بمقام العدالة، ويخشى ظلم من لا يحسن الكلام، وهذا غاية في الإنصاف والاعتدال.
2. الرحمة في تطبيق الحدود
عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يُكلم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: أسامة بن زيد، فكلّمه، فقال ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله؟… وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (رواه البخاري ومسلم).
وهذا ليس تشددًا، بل عدالة مطلقة لا تعرف محاباة، وهي قمة الاعتدال القضائي الذي يُزيل الفساد ويحفظ الحقوق.
وجاءه رجل يشتكي جاره، فقال ﷺ: «اصبر»، ثم كررها ثلاثًا، فلما كثر شكواه قال: «اطرح متاعك في الطريق»… فشكا الجار، وتاب. (رواه أبو داود).
سابعًا: الاعتدال في معاملة الأعداء
النبي ﷺ قاتل من قاتله، وعفا عمّن تاب ورجع. لم يكن يحب القتال، وإنما كان وسيلة اضطرارية للردع والدفاع.
في فتح مكة، لما ظن الناس أنه سينتقم، قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (رواه البيهقي، وصححه الألباني).
ولما قُتل رأس النفاق عبد الله بن أُبيّ، ترك النبي ﷺ الصلاة عليه بعدما نُهِي عنها، ولم يُمثل به ولا حرّض على أبنائه، مع أنه آذاه طويلًا.
هذا هو الاعتدال في معاملة الخصوم: عدل بلا ظلم، وعفو بلا ضعف.
ثامنًا: الاعتدال في الدعوة والتعليم:
1. التيسير في الدعوة
حين بعث النبي ﷺ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: «يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا»
(رواه البخاري ومسلم).
وهذه القاعدة الذهبية في الدعوة تمثل جوهر الاعتدال النبوي، وهي دليل على أن التيسير والرفق أقرب للقلوب من الشدة.
2. الرفق بالجاهلين:
جاء أعرابي فبال في المسجد، فقام الصحابة ليزجروه، فقال ﷺ: «دعوه، وأريقوا على بوله ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين» (رواه البخاري).
النبي ﷺ لم يُعامل الأعرابي بجفاء، بل اعتبر جهلَه سببًا للعذر، وربّاه برفق، فحُفِظ المسجد، ورُبِّي الأعرابي، ووقع الموقف في قلوب الناس وقعًا حسنًا.
كما دخل أعرابي المسجد وبال فيه، فثار عليه الصحابة، فقال ﷺ:«دعوه، وأريقوا على بوله ذنوبًا من ماء… إنما بعثتم ميسرين»(رواه البخاري)
تاسعا: الوسطية في الأخلاق والسلوك:
1. ضبط الغضب والتوازن النفسي:
قال النبي ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (رواه البخاري ومسلم).
فالإسلام لا يمنع الغضب تمامًا – فهو انفعال بشري – ولكنه يدعو لضبطه والاعتدال فيه.