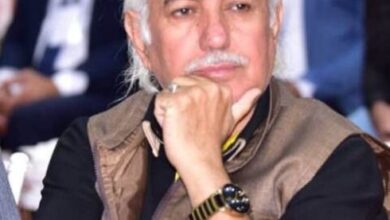سمية عبد المنعم تكتب .. في حضرة الحب يتوارى الغياب
 في حضرة الحب يتوارى الغياب، يخبو القلق والخوف، ويسطع نجم الأمان..
في حضرة الحب يتوارى الغياب، يخبو القلق والخوف، ويسطع نجم الأمان..
قالها يوما نجيب محفوظ ” إن أجمل ما في الحياة قلب تحكي له ما تشاء”، هذا هو فعل ممارسة الأمان، لا خوف ولا توتر ولا حسابات مسبقة، فإن وجد ما سبق بينما تهم بالحديث إلى من تظنه حبيبا؛ فأعرض عما تفعل، ولا تكن من المغفلين.. فلا يجتمع ضدان؛ الحب والخوف، كلاهما يفر من الآخر.
ولأنه لا تعريف بعينه يمكنه استيعاب معنى الحب، فليس هناك من قالب محدد مهما حاول البعض أن يجعله حاويا لمعنى شعور سامٍ كالحب، إن هي إلا اجتهادات لتعريفه.
على أن ما يمكننا التحلق حوله جميعا أن الحب الحق ما يمكنه أن يسمو فوق كل تعريف ويتجاوز أي قالب، أن يصل في معناه إلى ما قاله رب العزة في وصفٍ أرقى لمشاعر الزوجين “وجعل بينكم مودة ورحمة”، فجعل للحب معنى أشمل وأدوم وأهم، الرحمة والمودة، معنيان لا يرتبطان بتقلب مزاجي أو يتأثران بقرب أو بعد، بل يسموان فوق كل ذلك، فهما أكثر نضجا من مشاعر قلب يكمن بين إصبعي الرحمن، يقلبه كيفما يشاء.
وإن كان الحب لصيقًا بالقلب، فالمودة والرحمة لصيقان بالقلب والعقل معا، ينموان بالمواقف، يؤججهما التشارك، ويغذيهما التفاهم، هكذا يصبحان قطعة من القلب وجزءا من العقل، فلا يخبوان مهما شاء البعد وسيطر.
وفي الإطار ذاته يقول الروائى الفرنسى بلزاك: «الحب توافق بين الحاجات الحيوية والمشاعر الوجدانية»، ربطٌ بين احتياج فطري لوجود شريك ووليف، وبين سعي القلب الدائب لممارسة الشعور، وهو في حقيقته تعريف يجمع أيضا بين المادي والمعنوي، القلب والعقل، في اعتراف ضمني بأن الحب الذي لا يرتبط في جزء منه بالعقل لا يكتب له دوام على أرض الواقع، فلا ريح أشد من ريح الحياة وتغيراتها، هكذا يصبح تقلب القلوب أمرا مرهونا بمشاعر صرفة، أما الرحمة والمودة فلا يقلبهما ظرف ولا يفت في قوتهما أمر، ماداما صادقين.
وبغض الطرف عن كل شيء، يبقى الحب رزقا جميلا، وهبة ربانية يهبها الله من يشاء من عباده، أفلم يقل رسولنا الكريم واصفا حبه للسيدة خديجة “إني رزقت حبها”، وفصل الأسباب قائلا “آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس”، هكذا يصبح الحب في أجل صورة للرحمة والمودة، هبة سماوية ومنحة إلهية…
فاللهم ارزقنا حب كل راحم ومودة كل مؤمن بنا.